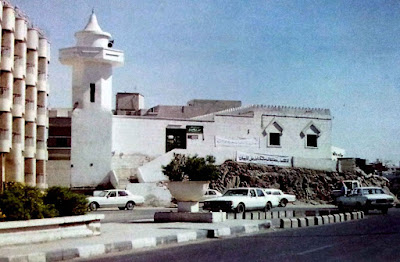ثنية
الوَداع
الوَداع،
(بفتح الواو)، اسمٌ من التوديع عند الرَّحيل(1). ثنية الوداع اسمها
القديم هو ثنية الركاب، إذ أخرجَ الطبراني في (المعجم الأوسط) عن جابر بن عبدالله
الأنصاريّ قال: خرجْنا ومعنا النساءُ التي استمتعنا بهنَّ حتى أتينا ثنية الركاب.
فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء النسوة اللاتي استمتعنا بهنَّ. فقالَ رسول الله r: "هن حرام إلى يوم القيامة"، فودَّعْننا عند ذلكَ، فسُمِّيتْ
بذلك ثنية الوداع، وما كانت قبلَ ذلك إلا ثنية الركاب(2). وبعض المؤرِّخين
يذكرها بلفظ الجَمع، ثَنيات، أخْذاً من شهرتها في أبيات الترحيب الشهيرة المروية
في قصة الهجرة، عند دخول النبي r
المدينة المنورة. وتلك الأبيات أخرجها البيهقي في (دلائل النبوة)
بسنده، عن ابن عائشة، قال: "لما قدم النبيُّ r المدينةَ، جعل النساء والصبيان والولائد يقلن:
طلع البدر علينا ** من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا ** ما دعا لله داع(3)
ولأهل
العلم قولان في تحديد موضع ثنية الوداع، التي كان دخول النبي r
المدينة عبرها.
أولهما،
أنها الثنية الجنوبية. وذلك أن رسول الله r
لما قدم من مكة، قدم من جهة جنوب المدينة، فلابد أن يكون قد
دخلها من تلك الجهة؛ وعليه تكون ثنية الوداع في جنوب المدينة، لوقوعها في طريق
مكة، الذي يمر ببدر. وحددها بعض بأنها المدرّج الذي ينزل منه إلى بئر عروة، في الجنوب
الغربي للمدينة.
محمد
حسن شُرَّاب أورد في (المعالم الأثيرة فى السنة و السيرة) تحقيقاتٍ تاريخية
وحديثية، في سياق إثبات أن ثنية الوداع الشهيرة إنما هي الشمالية لا الجنوبية،
وكان جوابه عما سبق بقوله: "أما أدلة القائلين بأن الثنية في طريق مكة، فليس
عندهم إلا خبرُ نشيدِ (طلع البدرُ)، وأنه قيل في مقدم الرسول r إلى المدينة يوم الهجرة، استناداً إلى أنّ فرحة أهل المدينة بمقدم
رسول اللّه r، إنما كانت يوم الهجرة. وليس عندهم إلا خبرٌ ضعيف، نقلَه ابن حجر
في (الفتح) قال: "وأخرج أبو سعيد في (شرف المصطفى r) من طريق عبيد اللّه بن عائشة منقطعاً، قال: لما دخل النبي r المدينة، جعلَ الوَلائدُ يقُلنَ: طلع البدرُ ...؛ قال ابن حجر:
"وهو سند معضل ...". وبالإضافة إلى ضعف هذا الخبر، فإنه لم ينصّ على أن
دخول الرسول r المدينة كان مقدَمَه من مكةَ، وإنما قال: لما دخل النبيّ المدينةَ.
وقد دخل رسول اللّه r
المدينةَ، عشراتِ المرَّات(4).
الثنية
الجنوبية ورد تعريفها عند ياقوت في (معجمه) بأنها "ثنية مشرفة على المدينة
يطؤها من يريد مكة"(5). وقال البكري: "ثنية الوداع، عن يمين
المدينة أو دونَها"(6). وذكر السمهودي بأنها سميت في عصره، بالمدرَّج،
وهو اسم حادث لها، وهي في العقيق، ومنها ينزل إلى بئر عروة(7). فهي على
هذا الوصف تكون في الجنوب الغربي للمدينة(8)، وتشرف على وادي العقيق،
وتحيط بها الحرة من كل جانب(9)، على طريق قباء، للمتجه إلى مكة، في
شمال شرق القلعة، على بعد كيلومتر واحد من مسجد قباء من تلك الجهة(10).
قال
الأنصاري: "وكما أن أهل المدينة كانوا يودعون المسافر منها إلى ناحية الشام
من الثنية التي هي بطريق الشام، فكذلك لهم أن يودعوا المسافر إلى جهة مكة من
الثنية الواقعة بطريق مكة، ويحق لكل من الثنيتين بهذا النظر أن تسمى ثنية الوداع،
لقيام معنى الثنية الذي هو الطريق في الجبل، والوداع، بكل منهما، ولاشتراكهما فيه،
فكلتاهما مركز لتوديع المسافرين"(11).
باحث
معاصر، عبدالله مصطفى الشنقيطي، أيد القول الأول، بأنها الثنية الجنوبية، وكان من
بين استدلالاته ما رواه ابن سعد في (الطبقات الكبرى) من حديث الهجرة، وفيه:
".. ثم هبط r بطن العقيق حتى انتهى إلى الجثجاثة، فقال: من يدلنا على الطريق
إلى بني عمرو بن عوفٍ، فلا يقرب المدينة ؟ فسلكَ على طريق الظبيَ، حتى خرج على العُصْبة،
وكان المهاجرون قد استبطأوا رسول الله r
في القدوم عليهم، فكانوا يغْدُون مع الأنصار إلى ظهر حرَّة العُصْبة فيتحينون قدومَه
في أول النهار، فإذا أحرقتهم الشمس رجعوا إلى منازلهم، فلما كان اليوم الذي قدم
فيه رسول الله r
وهو يوم الاثنين، لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول، ويقال: لاثنتي عشرة ليلة خلت من
شهر ربيع الأول ، جلسوا كما كانوا يجلسون. فلما أحرقتهم الشمس رجعوا إلى بيوتهم،
فإذا رجل من اليهود يصيحُ على أطمٍ بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا صاحبكم قد جاء.
فخرجوا، فإذا رسول الله r
وأصحابه الثلاثة؛ فسُمِعَت الرّجَّةُ في بني عمرو بن عوفٍ والتكبير، وتلبَّس
المسلمون السلاح"(12).
وهذا
النص هو أهم ما استدل به الشنقيطي، فهو صريح في أن الرسول r
سلك طريق الظبي، وطريق الظبي لا تزال معروفة باسمها إلى اليوم، وهي جزء من طريق
على ظَهر حرَّة بني سُليم، تبدأ من قباء إلى النَّقيع، وهو طريق مختصر وضيق ووعر.
قال الشنقيطي: "فلو تتبعنا سير الركب النبوي من الجثجاثة (وهي قرب أبيار
الماشي)، فنراه قد سلك على ظهر الحرة حتى هبط في القاع، من طرف القرين الأحمر (جبل
صريحة الموجود الآن في حديقة الملك فهد)، ثم صعد في حرة العصبة، وهذا هو اسمها إلى
الآن، وفي هذه الحرة مرتفعات ومنخفضات (ثنايا)، حتى انتهى إلى رأس الثنية الأخيرة،
واستقبله عندها المهاجرون والأنصار، وتلك هي ثنيات الوداع لمن كان مسافراً على
طريق الظبي"(13).
ويعلل
الشنقيطي إغفال كثير من المؤرخين لهذه الطريق، بسبب ندرة المسافرين عليها، وعدم
ورودها في الأخبار والرحلات من بعد الهجرة النبوية، الأمر الذي أدى إلى أن جهلت
لدى كبار المؤرخين والجغرافيين، وحتى لدى المختصين من المعاصرين، أمثال الجاسر،
والأنصاري، والبلادي. وقد أيد الشنقيطيَّ على هذه النتائج بعضُ المعاصرين من أهل
المدينة(14) . هذا ما يخص القولَ الأول، من كونها الثنية الجنوبية.
وأما
القولُ الآخر، والذي عليه أكثر المؤرِّخين، فهو: إنها في الجهة الشمالية، جهة
الشام. وهناك أدلة كثيرة تؤيد هذا القول، منها ما رواه البخاري في (صحيحه) عن
السائب بن يزيد، t، قال: "أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبيَّ r
إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك"(15). وأخرج
البيهقي في (الدلائل)، (باب تلقِّي الناسَ رسولَ الله r
حين قدِم من غزوة تبوك، وما قال في المخلفين من الأعراب بعذر
والمخلفين بغير عذر)، بسنده إلى الزهري عن السائب بن يزيدَ ، قالَ: "أذكرُ أنَّا
حين غزَا النبيُّ r تبوكَ، خرجنا مع الصبيانِ نتلقاه إلى ثنية الوداع". وفي
رواية: "تلقَّاهُ الناسُ، فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع"(16).
ومنها ما جاء في مرويات يوم ذي قرَدٍ، يوم أخِذتْ لقاحُ النبيِّ r، وفيه: أن أبا طلحةَ، t، عَلا ثنية الوداع، ونظر إلى بعْض خيُولهم، فأشرفَ من ناحية سلعٍ،
ثم صرَخ: واصباحاه(17). ومنها ما رواهُ أبويعلى عن أبي هريرة، t، قال: خرجنا مع رسول الله r
في غزْوِ تبوك، فنزلنا ثنية الوداع، الحديث(18). وفي (السيرة
النبوية) لابن هشام، في أخبار غزوة تبوك: فلما خرج رسول الله r ضرب عسكره على ثنية الوداع(19).
ومما
يدل على أنّ ثنية الوداع المذكورة في أخبار غزوة تبوك، هي الثنية الشامية، ما رواه
ابن هشام عن ابن إسحاق قال: ضرب عبداللّه بن أبيّ معه على حِدَةٍ عسكرَهُ أسفلَ
منه، نحو ذباب(20). وذُبابُ جبلٌ يذكرونه في تحديد ثنية الوداع
الشامية، فيقولون: "بين مسجد الراية الذي هو على جبل ذباب، ومشهد النفس
الزكية". وجبل ذباب، في أول شارع العيون بعد نزولك من الثنية، وأنت متجهٌ نحو
الشمال(21).
قال
ابن القيم في (زاد المعاد) عند حديث تلقي الصبيان والولائد، وذكر النشيد الشهير، قال:
"وبعضُ الرواة يهِمُ في هذا، ويقول: إنما كان ذلك عند مقْدَمه إلى المدينة من
مكَّة، وهو وهمٌ ظَاهر، لأن ثنيات الودَاعِ إنما هي من ناحية الشام، ولا يراها
القادم من مكة إلى المدينة، ولا يمرّ بها إلا إذا توجّه إلى الشام، وذلك يؤيده
الحديث: فلما أشرف r
على المدينة قال r:
«هذه طابةُ، وهذا أحُدٌ، جبل يحبنا ونحبه»(22). قال شُرَّاب: "ورؤية
جبلِ أحُدٍ للقادم من الشَّام أوضَحُ من رؤيته للقادم من طريق مكة"(23).
روى
البخاري في (صحيحه) عن ابن عمر، رضي اللّه عنهما، قال: أجرى النبيُّ r
ما ضَمَّر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع(24). قال
شراب: "الحفياء في الغابة شامي المدينة فيما يسمّى «الخليل» وثنية الوداع هنا،
هي الثنية الشامية، لأن ثنية المدرّج المذكورة في طريق مكة، لا تصلح أن تكون أمدا
للسباق من بداية الحفياء أو الغابة. بل إن المسافة من الحفياء إلى ثنية الوداع
الشمالية قرب سلع، هي التي تساوي خمسة أو ستة أميال، كما ورد في بعض الروايات.
وأما من الحفياء إلى الثنية الجنوبية (المدرج) فتبلغ ضعف تلك المسافة، فهذا دليل
آخر على كونها الشمالية"(25).
ثم
أردف شُرَّاب: "بقي دليلٌ قويّ على أن ثنيةَ الوداع في المدينةِ هي الثنية
الشامية، وهَذا الدليل هو: وراثةُ الأجيالِ من أهل المدينةَ، أنّ ثنية الوداع هي
التي في طريق تبوك، ورواية أهل المدينة في هذا المقام حُجَّةٌ، لأن أهل المدينة
أدرى بشعابها"(26). ومما يشهد لقول شرابٍ هذا، قول السمهودي:
"كل هذه الروايات متظاهرة على أن هذه الثنية هي المعروفة بذلك إلى اليوم، في شامي
المدينة"(27).
وعن
استبعاد بعض الناس كونها الشمالية، وأنه يتنافى موقعها مع كَون القادم من مكة إنما
يأتي من جنوب المدينة، فكيف يجمع بينهما؟.
أجابَ
السمهوديُّ بقوله: "إن ذلكَ لا يمنع من كونه في الهجرة عند القدوم من قباء،
لأنه r
ركب ناقته، وأرخى لها زمامها، وقال: دعوها فإنها مأمورة، ومر بدور الأنصار، حتى مر
ببني ساعدة، ودارهم في شامي المدينة، قرب ثنية الوداع، فلم يدخل باطن المدينة إلا
من تلك الناحية حتى أتى منزله بها"(28).
حدد
المؤرخون موقع الثنية الشمالية تحديداً دقيقاً، فقال السمهودي: "بين مسجد
الراية الذي على ذباب، ومشهد النفس الزكية، يمر فيها المارُّ بين صدَّين مرتفعين
قرب سلع"(29). وعن تحديد ذينك الصدين، يقول عبدالقدوس: "كان
الصدُّ الشرقي، المقابل لثنية الوداع الشمالية، فيه ثكنة عسكرية، وأما صدها الغربي
فكان خالياً من أي بناء، وكان مرتاداً للمتنزهين في ساعات الأصايل الجميلة،
لاحتجاب الشمس في هذه الأوقات وراء جبل سلعٍ من جهة، ولإشراف هذا الموقع على
المدينة وعلى أكثر ضواحيها وبساتينها وجبالها النائية والقريبة، من جهة أخرى"(30).
قال
العباسي: "وهي المعروفة اليوم [القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي]،
شاميَّ المدينة، خلف سوقها القديم، بين مسجد الراية الذي على باب ذباب، ومشهد
النفس الزكية قرب سلع"(31).
عبدالجليل
برَّادة (ت 1336هـ/ 1917م)، كتب تعليقاً على كلام العباسي، يذكر تحديدها في زمنه،
فقال: "هي الموضع الذي عليه القرين التحتاني، ويقال له أيضاً: كشك يوسف باشا،
ويوسف باشا هو الذي نقر الثنية، ومهد طريقها في حدود سنة 1214هـ/1799م"(32).
كلام برَّادة هذا غيرُ دقيقٍ، ولا يتفق مع كلام بقية المؤرخين، لأنه جعلَ القِرَين
التحتانيَّ هو ثنيةَ الوداع، وهذا غير صحيح. وقد ورد ذكر القرين التحتاني، وكشك
يوسف باشا، في (كتاب) علي بن موسى(33). وكلامه عنهما، ووصفه لهما، قاضٍ
بأن جبل ذباب، هو جبلُ الرَّاية، الذي يقعُ عليه مسجِدُ الراية، وهو المعروفُ بالقِرَين
التحتاني، لا ثنيةُ الوداع.
وصف
علي بن موسى موقعَ الثنية في طريق القادم إلى الحرم النبوي الشريف من الجهة
الشامية، بقوله: "وأما من كان مجيئه من الجهة الشامية، فمجمع طرق: العيونِ،
والجرُفِ، وسيدِنا حمزةَ، t، الثنيةُ، وتعرف الآن [1303هـ/ 1885م] بالقِرَين، بجوار الداووديّة،
فيكون جبلُ سلعٍ عن يمين الداخل"(34). وقال الخياري: "هي
الموضعُ المرتفع الذي يقع خلفَ محَطة أبوالعلا، خارجَ باب الشامي، ويسمى القِرَين"(35).
يلاحظ
هنا، أن كلام علي بن موسى، وكلام الخياري، يتفقانِ مع كلام برَّادة فيما سبق، من
أن الثنيةَ سُمِّيت في مطلع القرن الرابع عشر الهجري/ العشرين الميلادي، بالقرين
التحْتاني، وهذا مخالفٌ لكلام السابقين، فالقِرَينُ، كما سبق في كلامهم، إنما هو
جبلُ ذباب، والثنية بقربه؛ فليحرَّر.
عاتق
البلادي، في أواخر القرن الرابع عشر الهجري/ العشرين الميلادي، عرف ثنية الوداعِ
بقوله: "ثنية الوداع من سَلعٍ على متنه [طرفه الشمالي] الشرقي، يعرِفُها
الخاصّة من أهل المدينة، وفيها عُبِّد الطريقُ الذاهبُ إلى العيون والشهداء
والشام، وهي اليوم في قلبِ عُمران المدينة"(36). تلاه محمّد شُرَّاب،
بقوله: "هي الواقعة في بداية طريق أبي بكر الصديق (سلطانة) و أنت خارج من
المدينة، ويكون على يسارك اليوم، جبل سلع، وإلى يمينك بدايةُ طريق العيون المؤدي
إلى جبل الراية. فإذا كنتَ داخلاً إلى المدينة فإن جبلَ سلع على يمينك، وعلى يسارك
بداية طريق العيون، ثم بداية طريق سيد الشهداء المؤدي إلى جبل أحد"(37).
عبيدالله
كردي، الذي اعتنى بكتاب الخياري، علَّقَ بقوله: "قد أزيلتْ هذه الثنية حديثاً
في عام 1406هـ[= 1986م]، لصالح التوسعة"(38). كما أن محطة (أبوالعلا)
التي ذكرها الخياري لم يعُدْ لها وجودٌ اليوم(39).
بما
تقدم، يثبتُ أن هناك ثنيتين في المدينة المنورة، إحداهما جنوبيةٌ، والأخرَى
شمالية، تسمَّى كلُّ واحدةٍ منهما ثنية الوداع.
وأما
عن التسمية بالوداع، فقال ياقوت: "اختلف في تسميتها بذلك"، ثم أورد قولين:
القول
الأول: إنها تسميةٌ قديمَة من زمن الجاهلية، من قبل الإسلام، أطلقت على الثنيتين
معاً، لأنهما موضِعُ وَداع المسافرين(40)، على الجنوبية لأنها موضع
وداع المسافرين من المدينة إلى مكة(41)، وعلى الشمالية: لأنها موضع
الذاهب إلى طريق الشام(42). وهذا هو ما صحَّحه ومالَ إليه ياقوت، قال:
"والصحيح أنه اسم قديم جاهلي سُمِّي لتوديع المسافرين"(43)، وتبعه
الفيروزآبادي.
هذا
القولُ يؤيِّده ما أخرجَه ابنُ شبَّة في (تاريخ المدينة) تحت عنوان (ما جاء في
ثنية الوداع وسبب ما سُمِّيت به)، بسنده عن جابر t: قال: كان لا يدخل المدينة أحَدٌ إلا عن طريق واحدٍ من ثنية الوَداع،
فإن لم يعشَّر بها، ماتَ قبل أن يخرج منها. فإذا وقفَ على الثنيةِ، قيل: قد ودَّع،
فسميتْ ثنيةَ الوداع، حتى قدم عروةُ بن الورْد العبسيُّ، فقيل له: عشِّر بها، فلم
يعشِّر، ثم أنشأ يقول:
لعمري لئن عشَّرتُ من خشيةِ الرَّدَى ** نهاقَ الحَميرِ إنني
لجَزُوعُ
ثم
دخل، فقال: يا معشر اليهود، ما لكم وللتعشير؟ قالوا: إنه لا يدخلها أحد من غير
أهلها فلم يعشر بها إلا مات، ولا يدخلها أحد من غير ثنية الوداع إلا قتله الهزال. فلما
ترك عروة التعشير تركه الناس، ودخلوا من كل ناحية(44).
محمد
شُرَّاب في (معالمه) يذهب إلى تضعيف رواية التعْشيرِ هذه، ويقول: "إنّ رواية
وضع هذا الاسم (ثنية الوداع) في الجاهلية، ساقطة، لأنها مريضَةُ المتن والسند،
وليس لها ما يقوّيها، ولم يرد هذا اللفظُ في نصٍّ شعريٍّ جاهلي، أو روايةٍ موثوقة.
فإذا قيل: إنّ أنشودة (طلع البدر علينا) ورد فيها اسمُ ثنيات الوداع، وهي في بداية
الهجرة، ولو لم يكن المكان معروفا لما ذكره صبيان المدينة. أقول: إن سندَ ومتن
النشيدِ، لا يصمُدُ أمامَ الروايات الأقوى منه"(45).
القول
الآخر: إنه اسمٌ إسلامي، وأنها سميَتْ عقِبَ توديع النساء، في غزوة تبوك، لما روي عن
جابر بن عبدالله، t،
قال: إنما سميت (ثنية الوداع)، لأن رسول الله r
أقبلَ من خيبر ومعه المسلمون، قد نكَحُوا النساء نكاح المتعة، فلما كان بالمدينة
قال لهم: دَعُوا ما في أيديكم من نسَاء المتعة. فأرسلوهن، فسميت (ثنية الوداع)(46).
وعن القاضي عياض: سميت بذلك لتوديع النساء اللاتي استمتعُوا بهنَّ عند رجُوعِهم من
خيبر(47). قال شرَّاب: "الرواياتُ التي تذكر أن الاسْمَ إسلاميٌ،
كثيرةٌ وموثوقة ... وإذا ثبتَ أن الاسمَ إسلاميٌ، يسقطُ الاستشهاد بنشيد (طلع
البدر) على أنه قيلَ في بداية الهجرة النبوية"(48).
قُرْبَ
هذه الثنية كانت منازلُ أشجع بني قيس عيلان، القبيلة المعروفة؛ فقد أخرج ابن شبة
في (أخبار المدينة) أن أشجعَ نزلت الشعب الذي يقال له شعب أشجع، وهو ما بين سائلة
أشجع، إلى ثنية الوداع، إلى جوف شعب سلع. وخرج إليهم النبي r
بأحمال التمر فنثره لهم(49). وأخرج البخاري في (صحيحه)، ضمن أخبار
الفتن وعلامات آخر الزمان، أنه عند ثنية الوداع يموت آخر من يموت وآخر من يحشر من
البشر، عن أبي هريرة t، قال: سمعتُ رسول الله r
يقول: "يتركون المدينةَ على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العواف، (يريد عوافي
السباع والطير)، وآخر من يُحشَر راعيانِ من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما
فيجدانها وحشاً، حتى إذا بلغا ثنيةَ الوداع، خرَّا على وجُوههما"(50).
وحول
ما جرى من إزالة لهذه الثنية، وعن ضرورة الحفاظ على موقعها بتسميته التاريخية،
يتحدث عبدالعزيز كعكي، قائلا: "يعتبر جبل ثنية الوداع من المعالم المهمة في
المدينة المنورة، حيث تمثل الحدود الشمالية لمنطقة المناخة، كما لعب هذا الجبل
الدور المهم والبارز في المحافظة على موقع ثنية الوداع وحمايتها من الاندثار نتيجة
للتغيرات والمستجدات المتتابعة التي تخضع لها المدينة بشكل عام، فكان وجود هذا
الجبل بمثابة [هكذا] البرهان الصادق، والدليل الواضح لموقع هذه الثنية التاريخية،
التي ارتبطت أحداثها بتاريخ المدينة المنورة.
وبما
أنه أزيل هذا الجبل في عام 1406هـ/ 1986م، لضروريات التخطيط والتطوير التي تشهدها
المنطقة، فقد أصبح موقعُ هذه الثنية يخْشَى عليه من الضياع، فحبَّذا لو يحافَظُ
على ما تبقَّى من أرضِ هذه الثنية لبقاءِ موقع هذا المعلم المهم. وقد سعدت كثيراً
عندما أفادني أحدُ الزملاء بأن أمين المدينة المنورة قد أصدر توجيهاته بالبحث عن
موقع قريب من ثنية الوداع، لبناء مسجد آخر يسمى بنفس الاسم السابق [هكذا]، هدفه
المحافظة على موقع هذا المعلم المهم!. وحيث إن هناك زوائد وبعض المساحات الباقية
من موقع الجبل السابق، فحبذا لو كانت هذه المساحة موقعاً للمسجد الجديد، ليؤكد
الموقع الحقيقي لثنية الوداع"(51).
الهوامش:
1- ياقوت الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم
البلدان، جـ2 (بيروت: دار الفكر، د.ت)، 86.
2- الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم
الأوسط، تحقيق: طارق عوض الله، جـ1 (القاهرة: دار الحرمين، 1415هـ/ 1995م)، 287.
3- البيهقي، أحمد بن الحسين، دلائل
النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، تحقيق: عبدالمعطي قلعجي، ط2، جـ5 (بيروت:
دار الكتب العلمية، 1423هـ/2002م)، 266، وجـ2، 506.
4- شراب،
محمد محمد حسن، المعالم
الأثيرة في السنة والسيرة (دمشق:
دار القلم، د.ت)، 67.
5- ياقوت، جـ2، 86. الفيروزآبادي في (المغانم) تعقب
ياقوت في قوله عن الثنية الجنوبية: "يطؤها من يريد مكة"، بقوله:
"قال أهل السير والتاريخ وأصحابُ المسَالك: إنها من جهة مكة، وأهل المدينة
اليوم يظنونها من جهة الشام، وكأنهم اعتمدوا قول ابن قيم الجوزية في (هَدْيه)،
فإنه قال: من جهة الشام ثنياتُ الوداع، ولا يطؤها القادمُ من مكة البتَّة. ووجْهُ
الجمع: أن كلتا الثنيتين تسمى ثنيات الوداع". ينظر: الفيروزآبادي،
محمد بن يعقوب، المغانم المطابة في معالم طابة، جـ2 (المدينة المنورة: مركز
بحوث ودراسات المدينة المنورة، 1423هـ/ 2002م)، 707-708.
6- البكري، عبدالله بن عبدالعزيز، معجم
ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، تحقيق: مصطفى السقا، ط3، جـ4 (القاهرة: مكتبة
الخانجي، 1366هـ/1945م)، 1372.
7- السمهودي، علي بن عبدالله، وفاء
الوفا بأخبَار دار المصطفى، تحقيق: قاسم السامرائي، جـ4 (لندن: مؤسسة الفرقان
للتراث الإسلامي، 1422هـ/ 2001م)، 199، 461.
8- الأنصاري، عبدالقدوس، آثار
المدينة المنورة، ط3، (المدينة المنورة: المكتبة
السلفية، 1393هـ/ 1973م)،159.
9- الأنصاري، 160.
10-
الجهني،
فهد، ثنية الوداع لتوديع واستقبال المسافرين، صحيفة المدينة، العدد 16511،
4 رجب 1429هـ/ 2 يوليو 2008م.
11-
الأنصاري،
160. وقال: "يوافقنا العباسي في (تاريخه) للمدينة على هذا الرأي".
12-
ابن سعد، محمد بن سعد، الطبقات
الكبرى، تحقيق إحسان عباس، جـ1 (بيروت، دار صادر، 1968م)، 233.
13-
الأمين،
أحمد، باحث يحدد موضع ثنيات الوداع بجنوب غرب قباء ويستدل برواية طلع البدر
علينا، صحيفة المدينة، العدد الصادر بتاريخ: 29/10/2010م.
14-
منهم
سليمان الرحيلي، عميد كلية الآداب بجامعة طيبة. ينظر: الأمين، أحمد، المصدر السابق.
15-
البخاري،
محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ط3، تحقيق: مصطفى ديب البغا، جـ6 (بيروت: دار ابن كثير، اليمامة، 1407هـ/ 1987م)،
كتاب المغازي، باب غزوة تبوك، 10.
16-
البيهقي،
جـ5، 265.
17-
الطبراني،
سليمان بن أحمد، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، ط2، جـ7
(الموصل: مكتبة العلوم والحكم، 1404هـ/1995م)، 28، حديث 6278؛ البيهقي، جـ4، 187.
18-
أبويعلى،
أحمد بن علي الموصلي التميمي، مسند أبي يعلى، تحقيق حسين سليم أسد، جـ11
(دمشق، دار المأمون للتراث، 1404هـ/ 1984م)،
503، حديث 6625.
19-
ابن
هشام، عبدالملك بن هشام،
السيرة النبوية، تحقيق طه عبدالرءوف
سعد، جـ5
(بيروت، دار الجيل، 1411هـ/ 1991م)، 199.
20-
ابن
هشام، جـ5، 199.
21-
شرّاب،
68.
22-
ابن
قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق: شعيب
وعبد القادر الأرناؤوط، ط27، جـ3 (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1415هـ/1994م)، 551.
23-
شرّاب،
69.
24-
البخاري،
جـ1، 162؛ المؤلف السابق، جـ3، 1052.
25-
شراب،
69.
26-
شراب،
69.
27-
السمهودي،
جـ4، 196.
28-
السمهودي،
جـ4، 198؛ الخياري، أحمد ياسين، تاريخ معالم المدينة المنورة قديما وحديثاً،
(الطبعة السادسة، د.ن، 1424هـ/ 2003م)، 217.
29-
السمهودي،
جـ4، 196.
30-
الأنصاري،
160.
31-
العباسي،
283.
32-
العباسي،
283-284، الهامش. وهذه العبارة نفسها، نقلها عبدالقدوس عن تعليقات المرحوم ابراهيم
فقيه، ينظر: الأنصاري، 159، هامش 2.
33-
ابن
موسى، علي بن موسى، وصف المدينة المنورة (رسائل في تاريخ المدينة)، جمع
وتقديم: حمد الجاسر (الرياض: دار اليمامة للبحث والترجمة، د.ت)، 16، 18، 20.
34-
ابن
موسى، 47.
35-
الخياري،
217.
36-
البلادي،
عاتق بن غيث، معجم المعالم الجغرافية في السنة النبوية (مكة المكرمة: دار مكة،
1402هـ/ 1982م)، 246؛ البلادي، عاتق بن
غيث، معجم معالم الحجاز، جـ2 (مكة المكرمة: دار مكة، 1399هـ/ 1979م)، 94.
37-
شراب،
67.
38-
الخياري،
217، هامش 2.
39-
كعكي،
عبدالعزيز بن عبدالرحمن، معالم المدينة المنورة بين العمارة والتاريخ، جـ1
(بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1419هـ/ 1998م)، 283.
40-
ياقوت،
جـ2، 86؛ الفيروزآبادي، جـ2، 707.
41-
الفيروزآبادي،
جـ2، 707.
42-
الفيروزآبادي،
جـ2، 707.
43-
ياقوت،
جـ2، 86.
44-
ابن
شبة، عمر بن شبة، تاريـخ المدينة المنورة، تحقيق: فهيم شلتوت، جـ1 (المدينة
المنورة: حبيب محمود أحمد، د.ت)، 269.
45-
شراب،
68.
46-
ابن
شبة، جـ1، 269.
47-
السمهودي،
جـ2، 275.
48-
شراب،
69.
49-
ابن
شبة، جـ1، 162.
50-
البخاري،
جـ3، 27.
51-
كعكي،
284-285.
محمد
باذيب